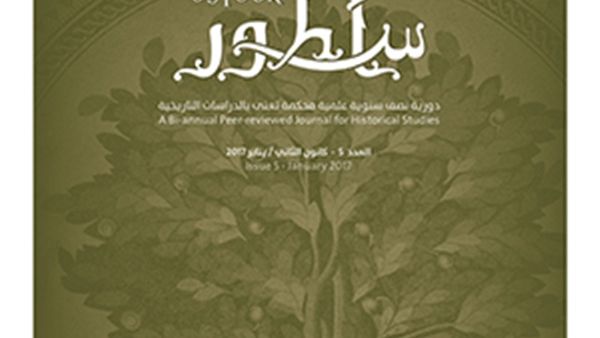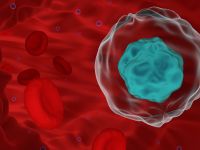صدر حديثا، عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد الخامس من المجلة النصف السنوية المُحكّمة "أسطور للدراسات التاريخية".
وقدّمت المجلة نخبةً من الدراسات وعروضًا بيبليوغرافيةً متنوعةً، إضافةً إلى باب الترجمة الذي اعتادت فيه المجلة ترجمة نصوص تاريخية، وختمت المجلة أبوابها بـ "ندوة أسطور" التي خُصِّص موضوعُها لتناول تدريس التاريخ في الجامعات العربية.
في باب "دراسات"، يُفتتح العدد بدراسة نظرية بعنوان "دور البحث العلمي في ضبط المفاهيم والمصطلحات: علم التأثيل أنموذجًا"، أعدّها الباحث الحسن الغرايب.
وتنطلق الدراسة من تصور يَعُدُّ "التاريخ كعلم يَجدُ نفسه معنيًّا بطريقة غير مباشرة بولوج اللسانيات"، على نحوٍ يُمكِّن من ضبط المفاهيم وجَعْلها ذات دلالةٍ بالنسبة إلى وجودها الفعلي؛ عبر العلاقات التي تُشكّل نسيجًا لا غنى عنه لإبراز حقيقة ما ترمز إليه، وبخاصة ما تعلّق منها بالمتداول اليومي المتميز بدلالة ما، تكون ذات حمولةٍ ثقافيةٍ وتاريخيةٍ لها ارتباطاتٌ بالواقع المعيش لكلّ مكوّنات المجتمع؛ سواء كان بدويًّا أو حضريًّا. والمفهوم ذاتُه مُحدّد في الزمان والمكان، و"يُؤَرْشِفُ" لهما وفق ما يرمز إليه، وإنْ تغيّرت الحقب لتداوله بحمولاته التي لن تبتعد نهائيًّا عمّا كان يعنيه ضمن المنظومة الثقافية لمجتمع ما.
أمّا الدراسة الثانية، فهي "الأساطير والطقوس المتشابهة في الحضارات القديمة والأديان" للباحثة آمال عربيد. وقد استعرضت فيها بعض الأساطير في الحضارات القديمة والطقوس المرتبطة بها، منذ وجودها، وهي أساطير تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد. كما استعرضت الباحثة تشابه الأساطير في جوهرها مع بعض معتقدات الأديان السماوية. وتتناول الدراسة ثلاث أساطير وثلاثة طقوس أساسية، استخدمتها الحضارات القديمة كأساس وجودي لتناميها واستمراريتها، ثمّ تشرح كل أسطورة خاصّة بكلّ حضارة على حدة، وتُبيّن ما هو مشترك بين الأديان السماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام؛ من حيث جوهر المعتقد، مع اختلاف الدلالة.
وجاءت دراسة "التحول من النظام التيماري إلى نظام الالتزام في لواء طرابلس العثماني"، وهي دراسة للمؤرخ السوري محمد جمال باروت، لتُقدِّم معالجةً لإشكالية العلاقة بين نشوء شريحة الأعيان النصيريين (العلويين) المحلّيين بالمعنى العثماني المحدد للتوسط بين الدولة والمجتمعات المحلية في جبل النصيرية، وبين التحول من النظام التيماري إلى نظام الالتزام في لواء طرابلس العثماني الذي كانت مناطق الجبل تابعةً له. ويطرح الباحث هذا التحوُّل كعمليةٍ تاريخية – اجتماعية - اقتصادية حدثت على مدى القرنين السابع عشر والثامن عشر، تعايَش فيها النظامان معًا، لكنّ النظام التيماري لم يعُد مهيمنًا، وصولًا إلى انحلاله الفعلي.
أمّا دراسة "معاهدة السلام بين إيالة الجزائر ومملكة السويد: 1729" للباحث عبد الهادي رجائي سالمي، فهي تحاول أن تُثبت أنّ أول علاقة رسمية بين الجزائر ومملكة السويد لا تعود، كما هو معروف، إلى بداية ستينيات القرن العشرين؛ إذ يلقي الباحث الضوء على معاهدة السلام والتجارة التي عقدت بين الجزائر والسويد سنة 1141هـ/ 1729م، وهي تُعَدُّ أول معاهدة بين مملكة السويد والجزائر. ويناقش البحث الأوضاع والحيثيات في المفاوضات والإجراءات التي حرصت السويد على اتّباعها من أجل إنجاح عملية التفاوض، والكيفية التي تمّ بها الاتفاق على عَقْد السلم بين البلدين.