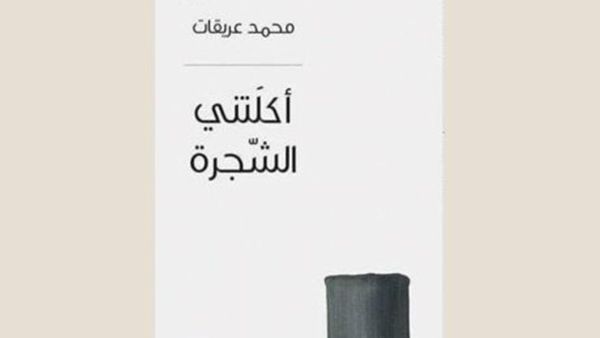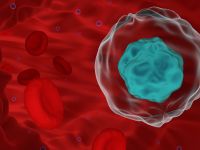بيروت- صدر حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ديوان «أكلتني الشجرة»، للشاعر الشابّ محمّد عريقات، ينهل خلاله من العوالم «الشعبيّة»، وحين نكاد نغرق في أجواء البؤس والفقر والمعاناة، تأتي مشاعر الحُبّ والإلفة من جهة مقابلة لتخلق نوعا من التوازن، بل يحدث أن الحبّ يغلق أبواب اليأس أمام تدفّق الألم وطُغيانه.
الشاعر يغوص في عوالم نعرفها ونعيشها واقعاً، لكنّ التعبير عنها، في تجارب أبناء جيله من شعراء قصيدة النثر، يظلّ نادراً وسطحياً، خصوصاً عند من يكتبون الشعر بروح نثرية، في ظل سيادة مفاهيم «حداثية» مغلوطة، لجهة الاهتمام بغياب بل «موت المعنى»، كما يحلو لبعضهم القول، وفقا لصحيفة «الحياة».
مع قصائد «أكلتني الشجرة»، نجد أنفسنا أمام «نفَس» شِعريّ مختلف، يبني قصيدة واقعيّة على قدر من الخشونة والقسوة. هي خشونة الواقع، وقسوة الحياة التي يعيشها الشاعر، أو الفئة/ الشريحة التي تمثّلها القصيدة. ففي قصيدة «قميص مشجّر… صحراء شاسعة»، يقول عريقات: «لم أرَ غيرَ الفقراء يتجمهرون حولَ ماكينةِ الخياطة/ بقلوبهم الممزّقة»، ويوغل في هذا العالَم: الفقراءُ/ هم أصدقاءُ السَكينةِ/ تنامُ أبوابُهم بلا أقفالٍ تنبحُ…».
إنّنا إزاء حشد من مفردات البؤس، صور الموت المتعدّد والمتدرّج، الجوع، الوحدة والعزلة والضجر، اليأس والانتحار. شِعريّة القصيدة هنا تتولّد من المفارقة، من رغبة في المواجهة، بل قدرة على خلق الفرح من الألم: «فرح صنعناه من حواضرِ البيت»، أو يكتب عن «قضمة للرفض من خبز رضانا».
وهو كثير العودة إلى عالم الطفولة، لكنّ الخشنة والقاسية «قلبي كثير الخدوش/ مثلَ ركبةِ الطفلِ»، ومع ذلك لا يزال ثمة ملامح من حميميّة ما في العلاقات، ففي قصيدة «ثلاثة مناديل لمناحة» نجد هذا التضامن والتعاطف في «حزن أمي على ابنِ جارتها/ وحزن جارتها على أخي/ الذي غابَ كطائرةٍ ورقيةٍ».
وكأيّ خارج على القوانين «قضيتُ مساءَ الأمس/ في لملمة نقودي من أكثر من بنطالٍ وحقيبةٍ»، يجترح عالمه الموازي «تشاغلتُ عن الوِحدة بكتابةِ قصيدة»، بل ثمّة ولادة للشيء من نقيضه «تعالي نتعلم المحبّة من قسوةِ الوحش».
إنه لا يريد من الحياة كثيراً من العُمر «نعِدُك أن نطلب الموت، بالهاتف، لحظة نكمل الخمسين». وأيّام الأسبوع عنده هي كائن حيّ، شخص يبدأ «منذُ عُنُقِ السَّبتِ وحتى ثُمالةِ الخميس»، وفي الأثناء يبوح «أقنعُ وحدتي باصطحابي إلى كرنفالٍ قرأتُهُ في الجريدة».
ولفرط بساطته، وبساطة قصيدته وعوالمها، نراه يناهض التصنّع، بل هو لا يتورّع عن التساؤل «لِمَ أبحث عن مفرداتٍ أقلّ فخامة من الشِّعر؟»، كما إنه يذهب إلى القصيدة العفويّة، وربّما يتركها تأتيه طائعة، لا تلك القصيدة التي «يجرّها الشاعرُ إلى الورقةِ من شَعرِها…»، ويسخر من هذا اللون من الافتعال «أنا شاعرٌ جاهليٌّ فضتُ على القافيةِ/ وقادت «فعولن» الذئب إلى قصيدتي من أذنه. وداستني الناقة في طريقها بي إلى الفندُقْ».