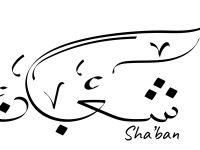خالد أبو الخير
تبدأ المقارنة بين الرجلين من تاريخيهما، فإياد علاوي، أول رئيس للحكومة العراقية الانتقالية، ومحمود جبريل رئيس أول حكومة انتقالية «المجلس التنفيذي» بعد ثورة 17 فبراير، خدما النظامين اللذين انقلبا عليهما، وتعذر عليهما الجلوس في مقعد الوزارة الأول، ما عد عقدة كأداء أمام طموحهما المشروع في عرف مؤيديهما، والمستحيل في رأي خصومهما.
لكن مقارنة جبريل بالعقيد معمر القذافي تبدو أصعب، تماما كما هي مقارنة علاوي بصدام حسين، وإن اتهمه خصومه ومنشقون عن مشروعه السياسي بأنه «ديكاتور» لم تنضج الظروف ليمارس طغيانه.
علاوي المنتمي للمذهب الشيعي والمتحدر من أب عراقي وأم لبنانية، والبغدادي المولد عام 1944، لم يعرف أنه ارتاد حلقات الدرس في حوزات العلم في النجف وكربلاء، مفضلا أن يخدم في حزب البعث، لينتهي بعد سنوات معارضا للرئيس القائد والزعيم الأوحد، وعلى دربه سار محمود جبريل، المتزوج من مصرية، والمتحدر من قبيلة ورفلة، الذي لم تشغل القبيلة باله كثيراً، ولا ولائم «البزين» في بني وليد، وصار ركنا ًاقتصاديا بارزا من أركان نظام الفاتح أبداً، بل ودبج أطروحة الدكتوراه في «التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار» التي حازها من جامعة بتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمرييكة، بشيء مما في الفكر الأخضر.
برز علاوي معارضا لنظام صدام حسين منتصف التسعينيات، رغم أنه انشق قبل ذلك بكثير، وأسس حركة الوفاق المعارضة لنظام بغداد، وجاء بروزه متساوقاً مع خطة أمريكية لإطاحة صدام، لم تلق هوى لدى الرئيس بيل كلينتون، فما لبث أن عدل عنها، ليدخل حزب علاوي بعدها في حالة سبات، استمرت حتى مجيء الرئيس جورج بوش الذي دشن الحرب على العراق في عام 2003.
لم تعرف عن جبريل معارضة لسياسات القذافي، وإن كان يستسهل الآن الحديث عن معارضته الصامتة.
في وقت كان المعارضون يتعرضون إلى حملات تصفية وتنكيل وتعقب من جهاز الأمن الخارجي «التصفية الجسدية» الذي رأسه قذاف الدم وموسى كوسا وبوزيد دوردة.
ويستشهد مقربون منه على معارضته للنظام برفضه جائزة في 2010 تحمل اسم «جائزة الفاتح التقديرية»، قائلين إنه حافظ، رغم تعيينه مديراً عاماً للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ثم مستشاراً، على مسافة بينه وبين النظام، ضاربين الصفح عن دوره الذي يقال إنه كان رئيسياً في تخطيط مشروع ليبيا الغد وجماهيرية سيف الإسلام ودستورها، وفق معارضيه.
وكما أقام علاوي في لندن مطولا، التي تعرض لمحاولة اغتيال فيها، وفق ما يروي، أقام جبريل مطولا في بتسبرج أستاذا في جامعتها قبل أن يتنقل في العديد من الدول العربية كمستشار تدريب وتنمية بشرية.
وإذا كانت الدبابات الأمريكية أوصلت علاوي إلى بغداد، والكثيرين يذكرون صورة مصافحته الشهيرة لبول بريمر، وابتسامته حين كان من ضمن واضعي الدستور الجديد، فإن بنادق الثوار وقصف الناتو أوصلا جبريل إلى بنغازي، التي رأى النور فيها عام 1952، ليتسلم مباشرة مسؤولية العلاقات الخارجية للثورة، ثم رئيسا لأول حكومة تنتزع الشرعية من المجتمع الدولي، وليطل على الليبيين مبتسما في الصور التي جمعته مع هيلاري كلينتون ونيكولا ساركوزي وكاثرين اشتون.
التركيبة الطائفية والسياسية في العراق الجديد لم تستوعب علاوي بوصفه بعثي سابق وعلماني ورجل أمريكا، فحورب، بعدما أجرت حكومته أول انتخابات ديمقراطية، ولم يحرز مقاعداً تؤهله للعب دور مهم. لكنه لم ييأس، وقاتل بشراسة، وأوجد القائمة العراقية التي اكتسحت الانتخابات الماضية بعد أن ضم إليها القوى السنية، بيد أن قبوله بالخيار «المر»، المشاركة في حكومة يتزعمها خصمه نوري المالكي أفرغت انتصاره من معناه، وجعلت العراقيين يتساءلون حول جدوى السير في ركابه.
تعزى إلى جبريل عملية تحرير طرابلس، لكن الرجل الذي وضع «ثوار» فيتو عليه، واضطروه إلى الاستقالة من المجلس التنفيذي، خاض غمار الانتخابات بكيانه السياسي «التحالف الوطني»، وحصد عددا معقولا من المقاعد.
الحرب التي تشن على جبريل تبدو على أشدها، فخصومه يتهمونه بالعلمانية وبكونه رجل أمريكا، بل القذافي الجديد. تلك الحرب التي انخرط بها مفتي ليبيا الصادق الغرياني، وقوى سياسية معينة، وجماعات مسلحة هي التي تحكم فعليا على الأرض، وقوى أخرى ترى من مصلحتها إقصاءه.
أقصي جبريل مرة عن رئاسة الوزراء لصالح مصطفى أبو شاقور، فآثر عدم خوض غمارها تارة أخرى، وهو موقف ترافق مع حديث عن «فيتو» ضده.
أقصى ما استطاعه علاوي هو المشاركة في حكومة يديرها خصمه اللدود نوري المالكي، وأقصى ما قدر عليه جبريل هو المشاركة في حكومة علي زيدان.
إلى هنا تتوقف المقارنة.. ليكتب بعدها الرجلان مصيريهما، ربما كلاً على حدة.
* عن "السبيل"