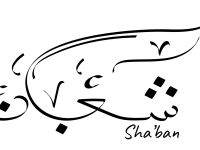تورطت اللغة العربية المعاصرة بمصطلح "الأمن القومي" نتيجة اعتماد مصر في ظل جمال عبد الناصر للالتباس في الكلمة الإنجليزية national والتي تتراوح في معناها بين الوطني والقومي، بما يناسب الدمج بين المستويين، والذي شاءه عبد الناصر بصفته الزعيم الوطني المصري والزعيم القومي العربي. ربما يكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستفادة من هذا الإبهام، إذ يختلط لديه أمن روسيا الوطني الذاتي، والأمن القومي لعموم الروس حيثما أقاموا.
ولكن رغم الحديث المتواصل في الإعلام الموالي لموسكو عن مبررات موضوعية، دون التفصيل الوافي، فإنه من الصعب استشفاف دوافع قرار الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا. حتى وفق معطيات المقاربة الواقعية للعلاقات الدولية، والقائمة على اعتبار حجم القوة والإقرار بمناطق النفوذ. وكان قد بدا أن بوتين يسعى إلى إرساء هذه المقاربة على حساب ما هو قائم للتوّ عالمياً، أي المقاربة المبدئية، والتي ترى وجوب الندية واكتمال سيادة الدول، صغرت أم كبرت.
من شأن هذا الاجتياح أن يأتي ببعض النتائج الآنية لصالح روسيا، ومن شأنه أيضاً تبديل واقع العلاقات الدولية، إنما بعيداً عن اتجاه الأحلام التي ما فتئت تراود من يترقب السقوط المدوي لنفوذ الولايات المتحدة في العالم.
منذ انهيار المنظومة الاشتراكية، ومن ثم الاتحاد السوفياتي، انضمّت دول عدة، بعضها من حلف وارسو، مثل بولندا ورومانيا وبلغاريا، وبعضها من "جمهوريات" الاتحاد السوفياتي السابق نفسه، ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، إلى حلف شمال الأطلسي. كما أن كلاً من أوكرانيا وجورجيا بدورهما، وهما كذلك "جمهوريتان" سابقتان ضمن الاتحاد السوفياتي، سعت للتفاوض مع دول الحلف بغية الانضمام إليه. غير أن هذا، خلافاً للضوضاء الإعلامية، لم يكن توسعاً لحلف شمال الأطلسي باتجاه تطويق روسيا والتضييق عليها، بل جهد له الكثير من المبررات لمنع روسيا من قضم هذه الدول أو الاستيلاء عليها.
للتذكير، فإن الزعم بأن الاتحاد السوفياتي كان يتألف من "جمهوريات"، أي عند الحد الأدنى كيانات تعبّر عن المصالح والتوجهات لشعوبها ومجتمعاتها، كان مجرّد ترتيب وهمي اجترحه لينين، مؤسّس الاتحاد السوفياتي، وهو المنظّر المعادي للرأسمالية الجشعة التي تستولي على بلاد الآخرين، والمنادي بوحدة عمال العالم والداعي إلى تحرّرهم. وأراد من خلاله التنصل من تهمة الاستعمار والإخضاع والإكراه، إنما مع الاحتفاظ بكامل فتوحات روسيا القيصرية مهما بعُدت.
واقع الأمر أن سائر الدول الاستعمارية الأوروبية اضطرت أن تتخلى عن مستعمراتها. أما روسيا، فما زالت تحتفظ بالعديد منها إلى اليوم. فكانت صيغة لينين الكاذبة بأن شعوب هذه الأراضي وهي التي خضعت بالأمس لروسيا بالقوة والإكراه، هي من اختار البقاء معها في اتحاد جمهوريات اشتراكية.
ترتيب ماكر دون شك، إنما التاريخ كان أكثر مكراً. ففي لحظة الضعف التي صاحبت انهيار الاتحاد السوفياتي، استحالت كذبة "الجمهوريات" حقيقة، وأشهرت هذه الدول الجديدة استقلالها، وسعت في معظمها إلى تأصيل هوياتها المشوهة التي أرادتها موسكو.
تشويه الهويات هذا، كان عبر فرض مفاهيم غريبة عنها لتبديد ما لا يلائم الحكم المركزي في موسكو. في آسيا الوسطى، كما في القوقاز، كان لا بد من تنشيط الأوجه الفئوية والقبلية منعاً لوحدة حال تقوم على ما لا يتوافق مع إرادة موسكو، أي الانتماء الإسلامي سواء بالمعنى الديني أو الأممي. "تركستان" كان قبل ذلك اسماً جامعاً، لكن دون بُعد سياسي واضح، غير أن تفضيل تجزئته جعل منه "أستانات" سوفياتية عدّة.
وكذلك الحال في القوقاز، الجنوبي منه والشمالي، حيث لم تكن التجزئة ممكنة، جرى اعتماد المزاوجة القسرية، كأن يُفرض على "الجمهورية السوفياتية" في داخلها جمهورية أخرى أو أكثر، أو مقاطعة أو أكثر، ذات حكم ذاتي، وتكون موسكو هي المرجعية في أي خلاف. وضمن "الجمهورية السوفياتية الروسية"، ولا سيما في القوقاز، جرى إلزام القوميات المتجاورة بأن تجتمع الواحدة مع الأخرى لتشكيل جمهورية ذات حكم ذاتي، لتحقيق "تآخي الشعوب"، أي لتجنب رسوخ الهويات القومية. وحدود هذه الجمهوريات والمقاطعات الداخلية، كما الجمهوريات السوفياتية، كانت مرسومة لأن تبقى القومية الاسمية لها في معظم الحالات أقلية لا أكثرية في جمهوريتها أو مقاطعتها.
في لحظة مكر التاريخ، أضاعت روسيا كل الدول التي استولت عليها في إطار حلف وارسو، وأضاعت كذلك كل أراضي روسيا القيصرية التي كانت قد زعمت أنها "جمهوريات" سوفياتية متآخية. وفي حالة الشيشان، كادت أن تفقد كذلك "جمهورية ذات حكم ذاتي" داخل الاتحاد الروسي. ولو استتب استقلال الشيشان، لكان سابقة ونذير انفراط الشريحة المتبقية من المجال الروسي الاستعماري التاريخي. أي المجال الممتد من فلاديفوستوك - ومعنى اسم هذه المدينة هو "قاهرة الشرق" - عند المحيط الهادئ، مروراً بسيبيريا وتاتارستان ووصولاً إلى داغستان وسائر القوقاز.
مقولة الشعوب المتآخية لم تكن يوماً صادقة في جوهرها. على أن التوجه العقائدي للعديد من المنظّرين الشيوعيين في الاتحاد السوفياتي، وبغضّ النظر عن الاستعمالات الوظيفية للمقولات القومية عملياً، كان يحبّذ الارتقاء إلى ما يتعدى الهويات القومية لتحقيق الوعي الطبقي، مع الإبقاء طبعاً على استعمال اللغة الروسية كلغة أممية جامعة.
ترقية اللغة الروسية إلى المقام الأممي لم يصاحبه تبديد للقومية الروسية. بل، كما تجلّى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، جرت تغذية الشعور القومي الروسي طوال عقود الشيوعية المفترضة. وكان ذلك بإقرار ضمني بتراتبيةٍ للأعراق والقوميات. وقد شهد عقد التسعينات من القرن الماضي، إصدارات مدهشة من "الدراسات" العرقية، والتي تُعيد الميول الإجرامية و"الوحشية" المفترضة في شعوب القوقاز مثلاً، كالشيشان وغيرهم، إلى عوامل وراثية شذّبها الانتقاء الدارويني.
جنوح الأجواء السياسية في روسيا ما بعد الشيوعية إلى اليمين القومي، بل العرقي، بل العنصري، لم يكن ردة فعل على الشيوعية. حيث أن هذه لم تتمكن من نفي المرجعية القومية. فغالباً ما يجمع اليمين الروسي إنجازات المرحلة الشيوعية والمرحلة القيصرية. كما يضيف إليهما قدراً من العرقية الصريحة في ميولها المتآلفة مع النازية الهتلرية وهي قراءات تستلهم هذه الأخيرة للتماهي مع الحركات القومية "البيضاء" على مدى العالم. الخلاف العقائدي لهذه التوجهات مع القيادات الغربية هو في العولمة التي تعتمدها، والتي تدفع باتجاه تذويب الهويات القومية، "البيضاء" الإجمالية، والتفصيلية، روسية كانت أم غيرها، في حدود الموروث المسيحي.
المجذوبون إلى روسيا في المحيط العربي، يتفاعلون معها وكأنها تجسيد قائم لمزاعم الفترة الشيوعية، في مناصرة قضايا الشعوب ومواجهة الاستعمار الجديد ونيّة التصدي للصهيونية. هذه المواقف، على افتراقها عن الواقعية والوضوح والنجاعة، لم تبلغ قط الحد النظري المقرّر لها في الزمن الغابر، وهي منذ انهيار المنظومة الاشتراكية لم تعد تندرج حتى ضمن هذا الزعم. وسلوك موسكو مناقض لها بالتأكيد. غير أن انشغال هؤلاء المجذوبين بترصد ما يبرر بُغض الولايات المتحدة، وتورطهم باستثمارهم الأهوائي بموالاة روسيا، يجعل من المراجعة والتراجع أموراً شاقة.
الخارطة البديلة عن خارطة الواقع الروسي الذي استتب في التسعينات، والمتداولة منذ ذلك الحين في الأوساط القومية الروسية، لم تقتصر على تأكيد الرغبة باسترداد المجال القيصري والشيوعي، بل وصلت بها إلى المطالبة باسترجاع ولاية ألاسكا الأميركية، والتي كانت روسيا قد باعتها بثمن بخس للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر.
مما لا شك فيه، ودون اعتبار للواقع المناقض للرغبات، فإن تاريخ روسيا في العقدين الماضيين وما يزيد، هو تاريخ السعي إلى "تصحيح" الخطأ التاريخي الذي أفقدها مقامها ومجالها. القسوة في الشيشان كانت المدخل ونقطة التحول، ولكن كافة خطوات بوتين يمكن تفسيرها في هذا السياق. وإذا كان التاريخ قد غلب الاتحاد السوفياتي، فإن بعض مكر هذا الأخير ربما يكون قابلاً اليوم للتدوير، في مسعى العودة إلى المجد الغابر.
أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، بحكمها الذاتي، كانتا الإسفِين في جورجيا في زمن السوفيات، وكانتا المدخل الجديد إلى جورجيا المستقلة عام 2008. وليعترض من يشاء، فإنهما اليوم قد عادتا إلى المجال الروسي، وإن بأقل صراحة من عودة القرم عام 2014. أما دونباس، بـ "جمهوريتيها" فهي المدخل إلى أوكرانيا، وإن لم تنطلِ الأكذوبة على أحد، يكفي تكرارها وتوزيع الصور التي تتحدث عن "إبادة" في دونباس، والتشديد على أن المجتمعات الروسية في كل مكان هي مسؤولية الاتحاد الروسي. ثمة مجتمعات روسية في دول البلطيق وكل دول آسيا الوسطى. هي أبواب قد يتطلب فتحها بعض الصبر.
أما مولدافيا المتاخمة غرباً لأوكرانيا، والتي تقوم على الضفة الشرقية من نهرها "جمهورية" انفصالية للناطقين بالروسية، فقد لا تنتهي "العملية العسكرية" في أوكرانيا قبل أن تبلغها، وتقتطع منها ما يطيب لموسكو تحقيقاً لقوميتها الجامعة.
في ظل المجاهرة بالمطالبة بالعودة إلى زمن السلطة القاهرة، كيف لا تسعى الدول المستهدفة إلى ضمان أمنها واستقلالها؟ حلف شمال الأطلسي هو توافق دفاعي، قائم على أن الاعتداء على أي عضو هو اعتداء على الأعضاء جميعاً ملزم لهم بأن يتدخلوا للدفاع عنه.
لماذا سعت أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي؟ ليس لغرض تهديد أمن روسيا الوطني والسعي إلى غزو موسكو بالتأكيد، بل لتجنّب الحالة القائمة اليوم: أرتال الجيوش الروسية تجتاح أراضيها وتعيث فيها خراباً، والصواريخ الروسية تدمّر مدنها، والهدف المعلن الصريح، من رئيس الدولة النووية المعتدية، هو إزالة "الغبن" التاريخي الذي سمح لأوكرانيا بأن تكون دولة مستقلة.
الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يتطلب الموافقة بالإجماع من كافة الأعضاء. ولروسيا في الحلف شركاء وأصدقاء، المجر بالتأكيد، وإيطاليا وفرنسا وحتى ألمانيا، لم يكونوا مطلقاً بوارد التشويش على علاقاتهم مع روسيا بقبول دخول أوكرانيا إلى حلفهم الدفاعي، أي أنه لوكان هدف بوتين منع أوكرانيا من أن تصبح أطلسية، فما كان عليه إلا التعويل على علاقاته السياسية والاقتصادية.
اجتياح أوكرانيا هو في واقع الأمر تفريط مرتقب بالأمن "القومي" الروسي، بالمعنى "الوطني". من شأن روسيا أن تستولي على بعض الأراضي، ولكن ثمن هذا المكسب هو مقاطعة اقتصادية صلبة وعزلة سياسية عالمية. بالإضافة إلى نتيجة مؤكدة، هي المزيد من توسيع حلف شمال الأطلسي، لأغراضه الدفاعية. جورجيا ومولدافيا، بالإضافة إلى فنلندا والسويد، نتيجة الاجتياح، تستعرض حاجتها إلى العضوية في هذا الحلف.
ولكن اجتياح أوكرانيا يندرج في إطار تحقيق الأمن "القومي" الروسي، من "القومية" العابرة للحدود الوطنية، إذ يجمع في الوطن أراضٍ ومجتمعات يريدها محسوبة عليه قومياً.
وهنا تكمن المعضلة. فحيث أن بوتين مستعد أن يضحي بمصلحة بلاده الوطنية، لتحقيق رؤية قومية، فإنه لن يتوقف عند أوكرانيا. مولدافيا قد تكون هدفه التالي. وما بعدها يشمل كامل التاريخ الروسي، السوفياتي والقيصري. لا بد من الإصغاء لهذا الرجل الخطر بتأنٍ، حين يتحدث عن الإضرار غير المسبوق بمن يقف بوجه مسعاه. ولا مفرّ من التصدي له.
حسن منيمنة - الحره